
| المنتدى الإسلامي العام يحوي قصص وروايات ومواضيع دينية نصية |
|
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
|
|
|
|
إضغط على
|
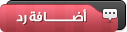 |
|
|
أدوات الموضوع |
من 5
عدد المصوتين: 0
|
انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||||
|
||||||
|
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: قصة سبأ في القرآن فإن الله -سبحانه وتعالى- قد قص علينا القصص لتكون عبرة لنا، (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ) (111) سورة يوسف، (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) (3) سورة يوسف، وهذا القرآن فيه من قصص السابقين ما هو مجال للتدبر والعبرة، وإعمال الفكر وأخذ الفكرة، وامتثالاً لقول الله تعالى: (فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (176) سورة الأعراف، نقص في هذه الخطبة قصةً من كتاب الله -عز وجل-، إنها: قصة سبأ، فبعد أن ذكر الله -تعالى- قصة آل داود في شكرهم لله، أتبع ذلك بحال من لم يشكر الله، والشكران سبيل المؤمنين، ومجلبةٌ للنعم، والكفران سبيل الجاحدين، مجلبةٌ للنقم، (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ) (15-17) سورة سبأ، وسبأ قبيلة من العرب، سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه، وقد روى فروة بن مسيك أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض أم امرأة؟، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن ستة، (أي سكنوا اليمن)، وتشاءم أربعة (أي سكنوا الشام)))، رواه أبو داود، وهو حديث صحيح، فلما أرسل الله عليهم سيل العرم أقام من أقام منهم وبقي، ونزح من نزح منهم وترك إلى الشام، كانت مدينتهم مأرب بين صنعاء وحضرموت، وكانت سبأ مملكةً عظيمةً في سلطانها، مهابةً في جانبها، قد حكى الله -تعالى- عنهم أنهم: (أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ) (33) سورة النمل، كانوا في نعمة وغبطة من بلادهم، واتساع أرزاقهم، وطيب عيشهم، وكانت زروعهم من الكثرة والخصوبة بحيث أن المرأة إذا دخلت وعلى رأسها المكتل بين الأشجار يمتلئ مكتلها ثماراً مما يتساقط من غير عناء ولا كلفة، كما قال قتادة -رحمه الله-، فبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه، وأن يشكروه على نعمته، وأن يوحدوه ويعبدوه، فكانوا كذلك ما شاء الله، ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل، والتفرق في البلاد، كما قال ابن كثير -رحمه الله-، (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ)، في بلدتهم مأرب اليمنية (آيَةٌ) علامةٌ ظاهرةٌ على العطاء والترفيه، ثم المنع والتخريب، (آيَةٌ) ظاهرة، وعلامة دالة على قدرة الله -عز وجل-، وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك، (أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) (64) سورة الواقعة، ولكن الله -عز وجل- أخرج من الأرض من هذا التراب، من هذا الخشب، ومن سيقان الأشجار هذه الثمار على اختلاف ألوانها وطعموها وروائحها، إنه القدير -سبحانه وتعالى- (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ)، ليس بعيداً عنهم، لا يحتاجون إلى وسائل نقل؛ لجلب المحاصيل من مكان بعيد، (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ) ليس المقصود بستانين، وإنما جماعات البساتين عن يمين الوادي وشماله، يشكل البساتين في اليمين جنة من تشابكها وكثرة شجرها، كأنها جنة واحدة كبيرة، جماعتان من البساتين عن يمين بلدهم وواديهم وشماله، وكان في ناحيتهم وادٍ عظيمٌ بين جبلين، وكانت جنبتا الوادي فواكه وزروع، وكانت كل واحدة من جماعة البساتين في تضامّها وتقاربها كأنها جنة، كما تكون بساتين البلاد العامرة، جنتان، هذه الكلمة توحي بما منحه الله هؤلاء القوم من الغنى، ووفرة الثمار، كانت بساتينهم ذات أشجار وثمار، تسر الناظرين، وكان من أمرهم أن الماء يأتيهم بين جبلين، وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم وبنّاؤهم المهرة، وكانوا أهل خبرة في هندسة السدود، فبنوا بينهما سداً عظيماً محكماً حتى ارتفع الماء، وصار على حافات الجبلين، فغرسوا الأشجار، واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، وكانت الثمار تتساقط من الأشجار دون حاجة إلى قُطّاف؛ لكثرتها، ونضوجها، واستوائها، فهذا سد مأرب العظيم بما علمهم الله -عز وجل- من اتخاذه وهندسته، وهذه الأمطار، وهذه المياه، وهذه الزروع والثمار والأشجار، نِعمٌ لاستقرار العباد، وآية من الله -عز وجل-، وأمنٌ وهو أساس العمران، وتمكنٌ من المياه وهي أساس الحياة، (كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ) على ما رزقكم من النعمة، واعملوا بطاعته، واشكروا له، وحدوه على ما رزقكم، واعبدوه لا شريك له، (كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ) كَرَمَ تلك الجنان التي أعطاكم، وما فيها من الخير الواسع، والأكل من رزق الله -عز وجل-، وهو المحسن الكريم، نعمة أخرج لكم ما تشتهون، ونسب الرزق إلى الربوبية، فقال: (كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ)؛ لأن الرزق من أفعال الله -عز وجل-، وتوحيد الله بأفعاله: من الإحياء، والإماتة، وإنزال والمطر، والرزق، ونحو ذلك، توحيد الربوبية، وعبادته وحده لا شريك له توحيد الألوهية، فذكر هذا مقدمة لهذا، وعلل هذا بهذا، فما دام أنه رب كريم رزق، فهو المستحق للحمد، والشكر، والعبادة وحده لا شريك له، كانت الآية العظيمة التي جعلها الله -عز وجل- في هؤلاء القوم ينبغي أن تقابل بشكر عظيم، (وَاشْكُرُوا لَهُ)، خصوه بالشكر، عطف الشكر على الأكل؛ لأن شكر الله -تعالى- سبب لاستمرار الرزق والزيادة منه، ثم بين أيضاً من موجبات الشكر (بالإضافة إلى الأكل والرزق) (بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ)، قال المفسرون: كريمة التربة، حسنة الهواء، سليمة من الهوام، لطيفة، جميلة، مباركة، معتدلة، لا حارة، ولا باردة، ولا جافة، ولا رطبة، ليس فيها ذباب، ولا بعوض، ولا براغيث؛ لاعتدال هوائها، وصحة مزاجها، وعناية الله -تعالى- بأهلها، كانت أخصب البلاد، ليست بسبخة، بل طيبة؛ لحصول الرزق الرغيد فيها، كانت من أخصب أرض اليمن وأثراها، وأعذبها وأكثرها جناناً، يسير الراكب من أولها إلى آخرها لا تواجهه الشمس، ولا يفارق ظلها؛ لاستتار الأرض بتلك الأشجار، وإحاطتها بها، فكان أهلها في أطيب عيش وأرفعه، وأهنأ حال وأرغده، هذا الصفاء في الفضاء، والطيب في الهواء، والتدفق في الماء، وقوة الشوكة، واجتماع الكلمة، فما الذي يعوق عن الشكر؟ وما الذي يبقى مطلوباً غير العبادة؟، (بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ)، لمن شكره وعبده، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ وماذا قال القوم؟ وما هو الموقف الذي وقفوه؟ وآل حالهم بعد النعمة إلى البطر والطغيان، قال الله -تعالى-: (فَأَعْرَضُوا) عن توحيد الله، (فَأَعْرَضُوا) عن عبادة الله، (فَأَعْرَضُوا) عن شكر الله، أعرضوا عن الحق، أعرضوا عن اتباع الأنبياء، ووقعوا في عبادة الكواكب، كما قال هدهد سليمان: (وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ) (22- 24) سورة النمل، فماذا فعل الله بهم لما أعرضوا؟ وبماذا قابلهم تعالى لما قابلوه بالكفران؟ قال الله: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) هذا إرسال عذاب، العرم: من العرامة، وهي الشدة والقوة، مطرٌ شديدُ، وسيل لا يطاق دفعه، والعرم هو: السيل الجارف، الشديد، الصعب، الغالب، الكثير، الشرس، المتناهي في الأذى، لا يرده شيء، ولا تمنعه حيلة، ولا يقوى عليه سد، بل يذهب كل مذهب، بل كان الله قد وهبهم القدرة؛ لبناء السدود، يتيهون بذلك على الناس، يحفظ الله به الأمطار، ويمدهم بما يحتاجونه طيلة العام، لكن هذا السد الذي تفاخروا به، وهذا المعلم من معالم القوة التي كانت عندهم، وهذا الذي افتخروا به على من حولهم، هذا السد العجيب، وهذه المنشأة الضخمة، وهذه التحفة الهندسية كانت سبباً في إهلاكهم، (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) لما أعرضوا عن الله، ولما كفروا بنعمته، وظنوا أنهم قادرون على رزق أنفسهم، أتاهم سيل العرم؛ عقاباً من جنس العمل، فسلط الله عليهم ما سلط، قال ابن عباس: لما أراد الله -عز وجل- عقوبتهم بإرسال العرم عليهم، بعث على السد دابة من الأرض، يقال لها: الجرذ نقبته، فخرب السد، وانهال عليهم التيار، واجتاح الأراضي، وأتلف الجنان والبساتين والزروع، ودمر البيوت والمنازل، وأغرق بلادهم، وأفسد عمرانهم، ويتّم أطفالهم، ورمّل نساءهم، ونزح من نزح منهم، فأُجلوا عن تلك الديار، ومُزقوا كل ممزق، هل يكون سبب الخير سبباً للعذاب؟ نعم، فقد عاقب الله -تعالى- قوم سبأ بالنعمة التي كانت لهم، ولما كان هذا السد سبب الخير المتدفق عليهم، صار بالكفران سبباً لدمارهم وتشردهم وتمزيقهم في البلاد، آية من الله -عز وجل-، وحكمة بالغة، وهكذا يرسل الله شيئاً يكون رحمةً لقوم، وعذاباً على آخرين، وابتلاء لقوم وإنذاراً وتخويفاً، وهو للآخرين أيضاً تمكين وقوة، ما هي العاقبة للإعراض؟ بعد النعمة كان لديهم الأمن في الأوطان، والأرزاق في الديار، والصحة في الأبدان، فتبدلت الأمور، وتغيرت الأحوال، فآلت إلى ماذا؟ قال الله: (وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ)، ثمرٍ مرٍ بشعٍ لا يؤكل، وقيل: الخمط كل شجر له شوك، وثمرته كريهة الطعم مرة، (وَأَثْلٍ) شجر البادية الذي لا ثمر له، أو ثمرٌ قليل الغناء، (وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ)، هذا السدر أحسن ما بقي، ولذلك ما أبقى لهم منه إلا القليل، (وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ)، وماذا يكون ثمر السدر بالنسبة لما كان من قبل، قال قتادة: كان شجر القوم من خير الشجر، فبدّله الله من شر الشجر بأعمالهم، بدلهم الله بالجنان اليانعة التي كانوا يعيشون فيها أشجاراً أخرى ليس لها ثمار، أو لها ثمار ليست بطيبة ولا لذيذة، حلت هذه الثمار المرة التي لا تؤكل بدل تلك الثمار النضيحة التي لها طعم طيب، والتي تصح منها الأبدان، (ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا)، (ذَلِكَ) أي: العقاب (جَزَيْنَاهُم) نحن بعظمتنا وقوتنا، (جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا)، وغطوا الحق، تبديل النعم بالنقم هو جزاء من لا يشكر، التبديل بعد المناظر الحسنة، والأنهار الجارية عندما تؤول القضية إلى ما آلت إليه من هذه الأجواء والأشجار، وهذه النتيجة عاقبة المعصية التي هي وخيمة، والتبعة التي هي صعبة، النفس المكذبة، النفس الجاحدة، النفس الكفورة، ولما كان من العادة المستقرة: المبالغة في جزاء من أساء بعد الإحسان: أجرى الله –تعالى- الأمر على هذا العرف، فقال: (وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ)، أي: لا نجازي إلا الكفور، لا نعاقب بمثل هذه العقوبة، ونسلب مثل هذه النعمة إلا الكفور المعاند المبالغ في الكفر، أما المؤمن فنكفر عنه ذنوبه بطاعته، ونزيد له في رزقه بشكرانه، إنه تهديدٌ يصدع القلوب، ويردع النفوس، ويدع الأعناق خاضعةً والرؤوس، وهذا الجحود والبطر هو السبب للخراب والدمار، والرجل يُحرم الرزق بالذنب يصيبه، وكذلك المجتمع إذا أعرض عن ذكر الله -عز وجل-، ومن الناس من يكون في رغد الحال، واتصال من النعم، فيرتكب زلة، أو يسيء، أو يتبع شهوة، فيتغير عليه الحال، فلا وقت ولا حال يظلم عليه النهار بعد أن كان ليله مضيئاً، وصلت زيادة نعمة الله عند أولئك القوم أن عمرانهم كان متصلاً بينهم، وبين القرى المباركة: اليمن مأرب مكة الشام، فيخرج المسافر من قرية ويدخل في أخرى في بلاد آمنة وقرى متواصلة، قال الله -تعالى-: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً) (18) سورة سبأ، القرى التي باركنا فيها بالتوسعة على أهلها بالنعم، والمياه، والزروع، والثمار، وحسن العمران هي قرى الشام كما قال مجاهد، أو صنعاء كما قال سعيد بن جبير ومالك، بينهما قرى ظاهرة: متواصلة يُرى بعضها من بعض؛ لتقاربها في ظاهر العين في الرؤية للناظرين، أو (ظَاهِرَةً) للمسافرين: بيّنة على الطريق، ليست بعيدة عن مسالك المسافرين، ولا تخفى على السائرين، (ظَاهِرَةً) قيل أيضاً: بكثرة أشجارها وثمارها، (وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ)، جعلنا بين قراها مقادير متساوية، فمن سار من قرية صباحاً، وصل إلى أخرى ظهراً، وقَالَ من القيلولة هناك، ومن سار بعد الظهر، وصل عند الغروب، وبالتالي لا يحتاج المسافر إلى زاد، ولا مبيت في أرض خالية، كأنه لم يخرج من قريته، فكانوا يسافرون من اليمن إلى بيت المقدس بلا زاد ولا ماء، فحيث ما نزلوا، وجدوا الخير والرخاء، والزاد والنماء، هذا كان من النعمة (سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ)، سيروا إن شئتم ليلاً، أو نهاراً، ليالي وأياماً، فإن الأمن لا يختلف عليكم، لا تخافون عدواً، ولا جوعاً ولا عطشاً، وإن امتدت مدة السفر، كانوا في أمان في الحضر، وكذلك في السفر، كانوا في رغد من العيش في بلدهم، وكذلك إذا سافروا من اليمن إلى الشام، (سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا)، قدم الليالي على الأيام، والظلام على الضوء والنهار؛ لأن مقام الامتنان بالأمن في الليل أكثر؛ لأن المسافرين أحوج إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهار؛ لما يكون في الليل من القطّاع والسباع، تأمين طرق السفر، تيسير المواصلات، تقريب البلدان يُسهل في تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق، فأنعم الله عليهم بنعم في الحضر وفي السفر، ولكن غلبت عليهم الشقوة، فلم يتعظوا، بل دعاهم داعي الحمق، والجهل، والكفران، إلى أن بدلوا نعمة الله كفراً، من بطر هؤلاء القوم أنهم قالوا: (رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا)، يا ليتها كانت بعيدة، فنسير على نجائبنا، ونربح ونفاخر، هل سمعت يا عبد الله بمن يمل العافية، ويسأم من توفر كل شيء؟، ثم يسأل ويدعو أن يكون هنالك تعب، ما هذا البطر الذي يؤدي إلى مثل هذا السؤال؟ ملّوا من النعمة، وبالرغم مما جعل الله في طريق سفرهم من القرى الظاهرة، والأمن والزاد، يقولون: (رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا)، فأحبوا المفاوز التي يحتاجون فيها إلى الزاد والرواحل، بنو إسرائيل كانوا في المن والسلوى، لكن ملّوا من النعم، فماذا طلبوا؟ (قِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ)، تريدون أن يحل هذا بدلاً من ذاك؟! عجباً! وهذا التشابه في حال قوم سبأ، وحال بني إسرائيل، فسبأ لا يريدون سفرات قصيرة، في منازل قريبة، ومحطات آمنة، وطرق فيها زاد وفير، كأن هذا عندهم لا يُشبع هواية الرحلات، ولذة المغامرة، فمن البطر أنهم طلبوا ما طلبوا (بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا)، وهكذا الفطرة إذا انتكست، والمزاج إذا انحرف يستبدل الإنسان القبيح بدل الحسن، وقد يكون هذا في الدين والأخلاق، وكذلك في المطعومات، والماديات المحسوسة، فيريدون الشرك بدل التوحيد، والخيانة بدل الأمانة، والفجور بدل العفة، وهكذا الرزق الخبيث بدلاً من الرزق الطيب، والحرام بدلاً من الحلال، مع قدرتهم على الحلال، لكن كأنهم ملّوا من الحلال، فيريدون حراماً، وهكذا الغرب لما سأم بعضهم الحلال اتجهوا إلى الحرام، ثم الاغتصاب، ثم اغتصاب العجائز، وبعض المشركين يرى فيه علاجاً من الأمراض، يرون العلاج من الأمراض في اغتصاب العجائز، (وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ)، سبأ بكفرهم، (فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ)، علكة في ألسن وأفواه الناس، (فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) تحولت الحضارة وتحولت القوة والعيش الرغيد إلى أحاديث الأماكن الآمنة والقرى المتقاربة صارت أحاديث، قصص، أخبار، يتحدث بها السمّار، صارت أثراً بعد عين، يُروى وليس بموجود، كان في قديم الزمان، (فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ)، كان في قديم الزمان، تُروى ويتعجب الناس من تلك الأحوال ومن مكر الله بهؤلاء ومن العبرة، (وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ)، كما يمزق الثوب، ففرق الله شملهم بعد الاجتماع والألفة، فصاروا في البلاد شذر مذر، وأصبحوا يقولون أي العرب في أمثالهم: ذهبوا أيدي سبأ، وتفرقوا أيادي سبأ، فلحق من لحق منهم بالشام، وذهب من ذهب منهم إلى يثرب، واتجه من اتجه منهم إلى بقية سهول تهامة، ما أهون الخلق على الله إذا عصوه، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك عيشاً رغيداً، ورزقاً وفيراً، وصحة في جسد، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، وأن ترزقنا طاعتك يا رحمن، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. |
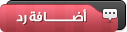 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| السد, انهيار |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 11:22 AM















 العرض المتطور
العرض المتطور







